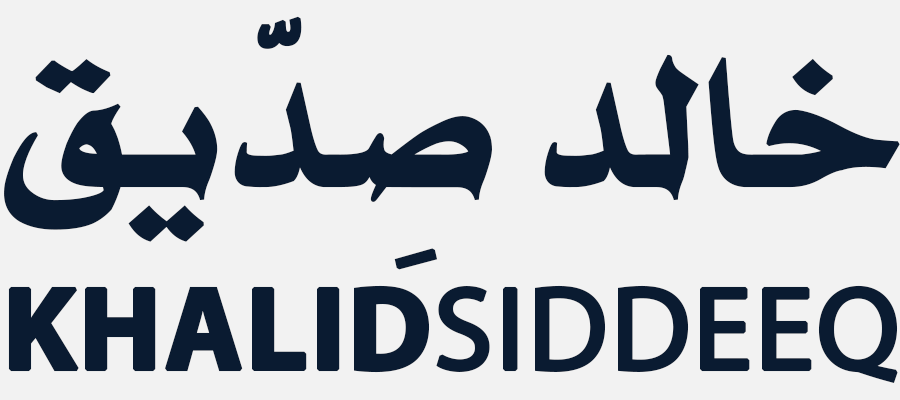لندن، الدهشة البائسة
منذ أن عرفت السفر، لم يسبق لي وأن خططت ماذا سأفعل في أول يوم عند وصولي للوجهة التي أقصدها، جرت العادة أن أتعمد الضياع وسط المدينة، تاركًا لنفسي فرصة التعرف على كل ما هو جديد ومختلف عني، صوت الشارع، ملامح الناس، اللغة، لوحات الشوارع، وحتى التخطيط العمراني للمدينة، كلها صفات وملامح تجعلني أصف الدهشة الأولى عند زيارتي لأي مدينة من مدن العالم للمرة الأولى.
أتذكر جيدًا، رغم مرور عقد وثلث منذ الزمن، كيف كانت دهشتي عند رؤية مدينة المنامة، ومن ثم اختلاف الدهشة بما تعنيه الكلمة، عندما وصلت إلى روما، كيف أن البنايات والشوارع، بل وحتى الرائحة، جعلتني في دهشة عظيمة ملئت يومي بأكمله، تلى ذلك عواصم بقية دول العالم، أصلها كنقطة بداية راغبًا استكشاف البلاد بأسره، عواصم حديثة مثل ريو دي جانيرو وطوكيو وموسكو وبكين، أو مدن صغيرة مثل لاباز وكوسكو وسمرقند، كل مدينة تصنع دهشتها بأسلوبها الخاص، هذه الدهشة لا تغادر مخيلتي وذاكرتي أبدًا، أتعمق في تفاصيلها، دهشة، تجعلني أصف ذات الزمان والمكان ولو بعد حين.
بعد ثلاثة عشر عاما من السفر، وصلت العاصمة البريطانية لندن لأول مرة، في رحلة عمل استمرت تسعة أيام، وهي أطول مدة قضيتها في عاصمة من عواصم دول العالم الأول، لم يسبق لي أن قضيت هكذا مدة في مدينة حديثة مكتظة بالسياح.
وصلت في السادسة والنصف صباحا، خرجت إلى شوارع المدينة أفعل ما اعتدت على فعله منذ عقد وثلث، التجول بلا هدف، الضياع وسط المدينة، محاولة الشعور بشعور الدهشة الأولى، كل ما وجدته هو العزلة، عزلة في وسط الزحام، مدينة مكتظة في وسطها، هادئة في أطرافها، عاصمة، يهتف الكل لزيارتها على مدى سنوات، لم أجد أي مبرر لزيارة عاصمة لإمبراطورية لم تغرب عنها الشمس في يوم من الأيام، ها قد حان الوقت، ثم لا شيء أكثر من يوم عادي ممل.
كسرت لندن قواعد الدهشة الأولى بحصولها على لقب أول مدينة لم تدهشني على الإطلاق، تذكرت على الفور توافد السياح كل صيف لهذه المدينة، بل وقد تغنوا بها في اغنياتهم، ولكن بالنسبة لي، قضيت عشرة أعوام أتجول بين دول كانت ضحية الإستعمار البريطاني، شنغهاي وهونج كونج ومكاو وبيليز وسيرلانكا وجامايكا وغيرها، حيث كنت أندمج مع الناس، مع الحياة، وكنت أيضا أرى كيف يعيش الجيل الحديث دافعًا ثمن المستعمر الغربي، إلى يومنا هنا. لم أنسى الإمرأة السيلانية المسنة، التي تعمل منذ طلوع الشمس حتى غروبه في مزارع الشاي، تقطف بيدها المجعدة ما يسمى بشاي الظهيرة الانجليزي، كي يستمتع به المستعمر، ولا أنسى كذلك الشوكولاته الانجليزية الفاخرة، والذي أخذت في الغالب من مزارع الكاكاو في بيليز، أو إحدى الدول الأفريقية الفقيرة.
ها هي لندن، أتجول بين شوارعها وأرى منازل عمرها يزيد عن قرنين من الزمن، المباني ذات الطوب الأحمر في وسط المدينة عتيقة للغاية، ولكن سرعان ما يتلاشى هذا الجمال عند حلول المساء، عندما يتحول وسط المدينة بمجمله إلى حانة ليلة مفتوحة، مليئة باللهو والرقص والتبرج ورائحة الكحول.
ثم ماذا بعد هذا الضجيج، ماذا عن الحياة في وضح النهار، رغم الزحام وكثرة عدد السكان، إلا أن الجميع اعتاد على العيش بعزلة تامة، كل شيء في المدينة يدعوا إلى الوحدانية والعزلة الاجتماعية، حتى وجبات الطعام في المحلات صممت بغرض عدم المشاركة.
أما عن متاحفها المجانية، فما هي إلا استعراض لآثار الحروب من جهة، وآثار الاستعمار وسرقات المواد الثمينة من جهة أخرى، مالذي آتى بالحضارة بالفرعونية إلى هنا؟ ومن أحضر بوذا الهند والصين؟ ماذا عن التحف الاسلامية التي رأيت نقوشها باللغة العربية والفارسية؟ الاثار الافريقية، لماذا كلها هنا في لندن؟ إنه المستعمر.
أما عن المعيشة، فهي باهظة التكلفة، أكاد لا أبالغ إن قلت بأن تكلفة وجبة الإفطار في لندن تعادل ميزانية يوم كامل في أحد مدن آسيا الوسطى، كيف يمكن للناس العيش هنا؟ لم أفهم الغاية من جمال هذه العاصمة التي حكمت العالم لعقود، عاصمة، يتبع العالم توقيتها بدقة، مدينة، جميع سكانها انجليز، حتى وإن كانت ملامحهم هندية أو افريقية او صينية أو حتى عربية!
سأكون إيجابيا بعض الشيء، وسأعترف حقيقة بأن هناك أمرًا واحدًا قد يشفع للندن، المسارح، مسارح تعرض بشكل شبه يومي منذ أكثر من سبعون عامًا، رواية البؤساء، الأسد الملك، وإحدى قصص أجاثا كريستي، هذه مسببات خففت من وطأة العزلة قليلا، فضلا عن الحي الصيني، الحي الذي ساهم كثيرًا في التخفيف من معاناة الأزمة اللندنية. الان، بعد أن رأيت عواصم عالمية عدة، أتسائل٬ هل لندن مدينة يشد لها الرحال؟ من يعرفني جيدًا يعرف كيف يمكن لإجابتي أن تكون.